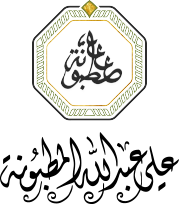بدأت رحلتي مع الكتاب منذ نعومة أظفاري، ففي الرابعة عشر من العمر كانت البداية، وترجع الرحلة الممتعة مع الكتاب لعاملين رئيسين، أولهما: أن الله سبحانه وتعالى أكرمني بنعمة حسن الخط في الكتابة، فقد بُهرت بالخط العربي ونماذجه وأشكاله وأنواعه، فجمعت الكثير من الأسفار التي تُعنى بهذا العلم، وفنونه، وتاريخه، وتطوره؛ وثانيهما: تشجيع أستاذ اللغة العربية لي على قراءة الكتب العربية، والتعمق في فروع المعرفة فيها من أدب، وشعر، وبلاغة، حين لاحظ تفوقي في حصص المطالعة والتعبير، وقد توج هذا الاهتمام بإهدائي ديوان الخنساء رضي الله عنها- الذي لا ازالت أحتفظ به منذ العام 1981- وكان هذا حدثاً بارزاً قادني إلى حب القراءة والمطالعة بشغف، وبهذا العام أرخت لتأسيس المكتبة العامرة التي أنعم بمحتواها اليوم.
في هذه المرحلة، بدأت ترتسم جلياً بدايات التوجه في الجانب الأدبي والفكري، وأضْفَت على ثقافتي لوناً ينظر إلى الكليات في معالجة النجاح والإخفاق، الانحطاط والنهضة، يرتبط بمرحلة سيادة العرب وريادتهم العالمية المُتوجة بحضارتهم التي طاولت الدنى، خاصة بين القرنين التاسع والثاني عشر الميلادي، لذا جاء الثراء المعرفي مرتبطاً بالمآثر الحضرية والمنجزات العلمية، وإقامة دعائم مجتمع المعرفة في هذه الحضارة، مثل: الأدب، والنثر، والشعر، والتاريخ، والجغرافيا، والعلوم من رياضيات، وفلك، وكلام، ومنطق، وفلسفة.
إلا أن انضمامي للمنظمة الشُرطية في أواخر ثمانينات القرن المنصرم، شكَّل إضافةً نوعيةً في نمط التفكير عندي، وجاء بأثر حسن في تقييمي للكثير من المواقف والأحداث، الأمر الذي أضاف بعداً اتسم بالواقعية في نظرتي للأمور، وربما كنتُ في حاجة إليها بوضوح في القادم من الأيام. نعم، مع هذا التحوُّل، بدأ اهتمامي يتداعى إلى العلوم المرتبطة بتصرفات البشر وسلوكهم، من إدارة، وعلم اجتماع، وعلم نفس.
وبعد ذلك، كان الحدث الأبرز الذي أحسبه نقطة انطلاق منطقية في إثراء المعرفة، وهو مواصلة دراستي العليا. ولما رأيت التعليم في الغرب يتصف بإمكانات عالية التقدم، وجدته المكان الأنسب لهذه الخطوة. وكانت بحق خطوة نوعية خلقت فضاءً رحباً، فمن جهة، فتحت لي آفاق جديدة في تطوير مكتبتي واحتضانها لمعارف متقدمة، ومراجع علمية حديثة بلغة العلم اليوم وهي الانجليزية، ومن جهة أخرى، كانت الفرصة في اكتساب معارف جديدة، وعلوم حديثة، منحتني الثقة في قدرتي لاحقاً على الكتابة والإسهام المعرفي، ليس في الجانب الإداري فحسب، وإنما أيضاً في العديد من مسارات العمل الشرطي الذي أوجد الحافز على تقدِيم أطر تتسم بالموضوعية في التطوير والتحديث.
وأخيراً نتعلم من الكتاب خالد الحكمة التي تقول، أن القراءة هي بوابة العلم، وأن العلم يؤدي إلى المعرفة، وأن المعرفة لن ينالها المرء إلا بالصبر والمثابرة، وبقدر ما يبذل من جهدٍ، ويكرس لهذه السَجِيَّة من وقتٍ، سيجد أعظم الفائدة التي ينتظرها الإنسان في نيل ما يصبو إليه من غايةٍ، وينجز ما رسم لنفسه من هدف، ويصل إلى ما سعى إليه من مكانة. والعرب تقول “ليس القَوَادِمُ كالخَوَافي”، وعليه، فالتفاوت بين البشر، بين الأمم، بين الحضارات، لا يأتي إلا بسلطان العلم، وهذه سُنَّة كونية، يستطيع بها المرء إدراك ذلك في حاضرنا اليوم، فضلاً عما تركه السلف من آثار، وبقايا، وأطلال.